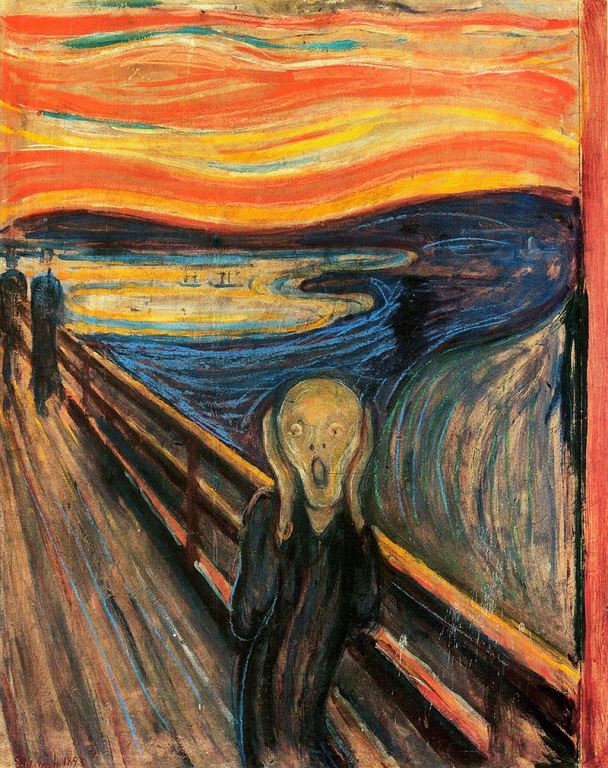في التيه/ ماجد عاطف
ما كان لي أن أتعرض لخالد أو أتتبعه مباشرة، كما فعلت. كان عليّ أن أومئ إيماءً وأشير إشارةً واللبيب يفهم من تلقاء نفسه. لقد درست كل كلمة كتبها وكل كتاب وافق على نشره وكل خطبة مسجلة استطعت الحصول عليها
(إلى أ الذي سألني: فقط لأقرّب لك الجواب..)
|ماجد عاطف|
 انكشف أمر خالد فُرجة وهرب إلى كندا. هكذا، باختصار، قالت القناة الرسمية.. لم أتابع التفاصيل بل اكتفيت بالخبر الرئيس وهو يخرج من فم المذيع، وأغلقت التلفاز. كان مزاجي يعرج على خواطر بليدة من دون شعور، فلم اهتم بالخبر نفسه (لسنوات تردد مضمونه في رأسي آلاف المرات)، بل فكّرت في هيكله: جوانب شكلية يُسلّط عليها الضوء، وأخرى حيوية مُغفَلة، وتوجيهٌ موظّفٌ أو تأليبٌ بذيءٌ. الحقيقة في التفكيك والتركيب. تمتمت وأنا أرى نصفي الأعلى محدباً في شاشة التلفاز السوداء.
انكشف أمر خالد فُرجة وهرب إلى كندا. هكذا، باختصار، قالت القناة الرسمية.. لم أتابع التفاصيل بل اكتفيت بالخبر الرئيس وهو يخرج من فم المذيع، وأغلقت التلفاز. كان مزاجي يعرج على خواطر بليدة من دون شعور، فلم اهتم بالخبر نفسه (لسنوات تردد مضمونه في رأسي آلاف المرات)، بل فكّرت في هيكله: جوانب شكلية يُسلّط عليها الضوء، وأخرى حيوية مُغفَلة، وتوجيهٌ موظّفٌ أو تأليبٌ بذيءٌ. الحقيقة في التفكيك والتركيب. تمتمت وأنا أرى نصفي الأعلى محدباً في شاشة التلفاز السوداء.
خلال أيام تذكرني بعضهم، فتوالت عليّ زيارات قضت على عزلتي ونصف كيلو القهوة المعتاد الذي أشتريه كل شهرين. كانوا يحاولون الاعتذار لي عن (التقصير) و(الانشغال) ويوجهون لي الدعوات للزيارة أو حضور حفل الانطلاقة القريبة كضيف خاصّ، أو يسألون إن كنت بحاجة إلى مساعدة أو أي شيء.
أبو يزن، صاحب مكتبة الإحسان، الذي يبيع كل أنواع الكتب جاهلاً مضامينها (ولو بحثت عن مؤلفات هنري ميللر أو د هـ لورنس لوجدتها عنده)، إضافة إلى التسجيلات الإسلامية (وتوجد عنده كذلك عطور وبخور، وأنواع مختلفة من العسل أو حبة البركة أو السواك)، كان من هؤلاء. بعد السلام والتحايا والمباركة لي بمولد حفيدتي (لم أرها ولم أر أمها/ ابنتي منذ فترة طويلة) وبعد تداول الأخبار “الضرورية” والماشاءالّات المتوسّعة مع ابتسامات الرضا والحمدلات اللفظية، أراح أبو يزن راحته على كتفي، كأنه صاحب حميم:
- ناشدتك بالله أن تخبرني كيف اكتشفت أمره، هو الذي كان نجمه صاعداً والجميع يهتف باسمه.. مجاهداً.. وناشراً.. وكاتباً.. وخطيبَ أيامِ الجمع؟!
الحماسة.. الادّعاء.. التقرّب.. التودّد.. التقعّر في الكلام، كلها أمور أخاف من أصحابها. راحته كانت ثقيلة على روحي قبل كتفي. أبعدتها عني بضيق وتململ فاستردها:
- من تعني؟؟
- الشيخ خالد فُرجة.. استغفر الله: الكلب خالد..
لا أثق بشيء، إذا كنت مهتماً به، إلا بعد تقليبه على وجوهه وتعريضه لسياقات مختلفة والتحقق منه. صار (الشيخ) خالد فُرجة كلباً، ويعلم الله وحده أي جهة خفية الآن تستفيد من كشفه، بعد أن كانت تستفيد من تلميعه وتسويقه. من متابعتي لتفاصيل المحاكمات، رأيت أن الذي يُدان بالخيانة مثلاً، يُدان تغطية على آخرين بعد أن تكون عملية أو أكثر قد تكشّفت للناس وتورطت فيها أسماء كبيرة.. يبحثون عندها عن كبش فداء لم تعد تستفيد منه المخابرات الإسرائيلية، ثم يحكمون عليه حكماً شكلياً (إما أنه لا ينفذ أو أن تنفيذه لا يمكن التحقق منه)، تماماً كبعض عملياتهم الفدائية العريقة التي كان الاحتلال، وحده، يؤكّد نتائجها البطولية وأرقامها الصعبة وأنفاقها التاريخية..
قد يعلنون أنه اعدم أو مسجون، لكنه في اليوم التالي يكون في تل أبيب، أو في دولة عربية باسم جديد، أو أي مكان آخر في العالم يتجسّس على جالية عربية أو فلسطينية. باختصار: إعادة تدوير.
///
أبو يزن قبالتي. ملامحه ذكرتني بملامح محرّر كنت أتعامل معه، ملامح من يلعب وفق قواعد محدّدة، اليوم لك؟ صحة، إذا وقعت في الغد سيصير عليك: إذا احتوى مقالي المرسل على خطأ (حتى لو استدركته بعد ساعات فقط بمقال تصويبيّ)، يُنشر الذي فيه الخطأ، ثم يُستعمل الخطأ نفسه للتعريض بي واستدعاء ردّات الفعل وبالتالي نشر مقالات أخرى.. حسبت الأمر مجرد خطأ أو نزعة آكشن صحفيّة، فأرسلت مقالا يحتوي أخطاء بعد المقال الصحيح، ونُشر مع ذلك الثاني لا الأول. ولأحمي نفسي، إضافة إلى تسجيل الفيديو والتوثيق الالكترونيّ، أشهدت اثنين على كل خطوة من وضع عنوان البريد الالكترونيّ وإرفاق الملفات إلى النشر الورقيّ الذي لا يمكن التلاعب به بعد الطباعة، فانفضح المحرر.. وجدت أنّ الأمر أخطر بكثير من مجرد الإثارة.
قلت بحذر:
- لم أكتشف شيئاً.. إنما لم أقتنع به، فقط كانت لدي ملاحظات.
- مثل ماذا؟
مرّت برهات ثقيلات على أنفاسي. حسبت أنني لن أجد شيئاً أقوله. ربما لأنني قد اعتدت القطيعة والصمت. تمرّ أسابيع وقد لا أكلم إلا القط. المشتريات أطلبها عبر الهاتف أو الانترنت وتصل لباب المنزل، والفواتير تُدفع آليًّا مثل تعويضي الشهري حين ينزل إلى المصرف. يساعدني محمود الممرض في الأشياء التي لا أستطيعها وحدي. عندما يشقّ الصمت عليّ وتتخابط الأفكار في رأسي أو يزيغ بصري، أتلو القرآن لأسمع كلام الله وصوتي.
أتمنى لو أني أتقن الصمت، غير أنّ الكلام يتفرقع من فمي كحبات ذرة مسّتها النار:
- من المفترض أنه ناشر إسلامي ملتزم، هكذا في البداية تعرفت إليه.. وفي هذه الحال لا يمكن السماح بنشر أيّ أفكار تمس العقيدة بينما أجاز هو نشر كتب أدبيّة، ليبرالية، فيها “تشبيه” و”حلول” و”أنسنة” للرب عدا عن التكشّف والحسّيات، طمعاً في علاقات نافعة مع أصحابها الأدباء المكرّسين.
وابتلع ريقي لأنّ الكلام خطير. ينبغي أن أكون دقيقاً، فكلّ كلمة ستحسب عليّ.
- كذلك وجدت هذا الملتزم الإسلامي وحدوي الأهواء والأنشطة، لا مشكلة له في التعاطي مع أفكار الملحد أو “الجندريّ” مبيح الشذوذ أو حتى المشاركة في أعياد الميلاد، بينما يعرِّض في كلّ مناسبة بحركة إسلامية.. وجدته يردد أشعار الدرويش التي هي إسرائيليات محضة، ناهيك بإيديولوجيتها المعلنة وإباحيتها الصريحة (في ذلك الوقت لم تكن قد انكشفت بعد قصة الجندية الصهيونية أو فتيات الكيبوتس) ويظلّ يدافع عنه، في حين لا يتردّد في التشهير بـ “فاسق” مضى على زواجه ممّن فسق معها ربع قرن (والفسوق أنه قبّل ومسّ حين كان صغيراً!)..
سكتّ. شعرت بالاستغراق فوق عيني، في جبهتي، كأني أخوض سحاباً أو تيها، فتأملت أبا يزن كنقطة أركز بصري عليها. وجه مستدير متورّد ولحية عصرية محدّدة تشذّبها آلة الحلاقة كل عدة أيام. قبل أن تستقرّ الرؤية خيل إليّ أنّ البدلة والسروال الأسودين، معاً، فوهة بئر غامضة.
أخاف الناس.. لا ليس الناس، ما هم إلا قطعان تمشي وراء أكباش خصاها الراعي ليسيطر عليها.. الآن يصغي أبو يزن باهتمام أو يتظاهر بذلك، لكن طوال السنوات السابقة، كم أساء فيّ الظن ونمّ عليّ وأكل من لحمي؟؟ دار الدولاب والأيام دالت ورجحت لي الكفة. مع رغبتي الشديدة في السكوت والصمت، أكملت بعنف كأنني أنتقم، لا أدري حقاً ممن:
- أخطر ما وجدته أنه يقيم صداقات مع أجهزة الأمن (التي تنسّق أمنياً مع الاحتلال واعتقلت حتى أعضاء حركته) بحجّة أنّ العناصر معتقلون سابقون كانوا معه في السجن؛ ويقيم علاقات مع مؤسّسات أوروبية متصهينة وأخرى صهيونية (لم أفهم أبداً سبب وجود برنامج تحرير بالعبرية على حاسوبٍ في داره للنشر: لمن يكتب -أو ينشر، أو يراسل- بالعبرية؟؟)؛ ولديه استعداد ليتحالف -في ندوة عقدتها جامعة- مع ماركسي وعلماني تحت إدارة امرأة مسيحيّة، فيهاجم حركة إسلامية أخرى. لم أقتنع لا بشخصه أو جهاده ولا بحركته التي ينتمي إليها، طالما سمحت له بكل ما سبق.
في الحقيقة أخذت أيضاً أتتبع تفاصيله الأخرى.. أين عمل وعن طريق من، ومضمون صداقاته، ومن تزوج وعائلته، وأين سكن وأشياء كثيرة، فأثرت الانتباه وجلبت لنفسي الأسئلة والشكوك. كان معدوداً من الكوادر.. تبيّن لي أنه يستند على السائد ولو خالف الدين، يمشي مع التيار.. أيّ تيار، متسلق، يسوّق نفسه ويحب الإعلام، وكلها أمور لا تستقيم مع شخصية مسلم حقيقيّ.
ضحك أبو يزن وغطى ضحكته براحته:
- أنت تكرهه كرهاً شخصياً، اعترف..
هناك شيء في السؤال، رغم الضحك، مقيت. كنت أكرهه حقاً، لكني لست واثقاً من السبب، فحاولت اكتشافه:
- نعم، لا أحبّه.. حين رأيته في المسجد، اعتقدت أنه مكلف بالإمامة/الخطابة ثم تبيّن لي فيما بعد أنه “متطوّع” لوجود قريب له في الأوقاف، في الوقت الذي يُبعَد فيه مئات الأئمة والخطباء المعروفين عن المساجد. خطب مرة.. (طبعاً يجهل أنه يقع في أخطاء لغوية فظيعة لا يقع فيها تلميذ مدرسة). يعتقد أنّ رواد المساجد أناس لم يعرفوا شيئاً ويستطيع هو المجاهد المناضل، الشيخ العصري، المثقف الخطيب أن ينوّر عقولهم ويوسّع آفاقهم.. بماذا ينورهم؟؟ بحكايات مثل حكاية الفراشة والإعصار التي ما كفّ مسلسل مترجم أو إعلام سطحي، عن تكرارها.. مع ذلك كان يجهل، حين واجهته بعد الصلاة، أنّ للحكاية أكثر من تسمية من بينها نظرية الفوضى وأنها صياغة أخرى لقانون جدليّ ماركسيّ هو “التأثير والتأثير المتبادل”. كانت تستخدم تحديداً لنفي وجود الإله، لا لإثبات حكمة الله سبحانه وتعالى في تداخل تفاصيل مخلوقاته. جادل ورفع صوته رغم أني حرصت على عدم فضحه على الملأ، فلم أقبل بمجادلته. أشهدت الله عليه ومضيت.
نعم أكرهه وأكره أبا يزن وأكره الجميع. مخالطة الآخرين واجبة، لكني لا أحلم سوى باعتزالهم. لحظتها لن أنشغل بأحد وسأصفو بدل أن ألاحظ وأتكدّر وأفكّر واضطرب. لن أقلق وسأدع عني الفضول وسأنشغل بنفسي.
مع ذلك تذكّرت، فهتفت:
- بعد خطبة، أعلن على المنبر أن كتاباً فقهياً -ألّفه هو- سيُوزَّع أمام أبواب المسجد كصدقة جارية.. بعد قليل أضاف.. إنه يقبل التبرعات ممن يرغب في تقديمها. وتبرّع الناس بسخاء مغترّين. لم أسترح للأمر. ما أسهل في أيامنا أن يصير أي شخص كاتباً، لكن أن يروّج لنفسه في بيت الله؟ أن يستغفل الناس؟؟ لو عرض بضاعة، لكان بالإمكان تقييمها: هل تستحق ثمنها أم لا.. لو قدّمها، كما قال، صدقة جارية، لربما شفعت له نيته بعيدا عن مضمون كتابه. غير أنه أراد الأمرين معا أو بالأحرى أراد أمراً عبر آخر.. شعرت بالسخط وابتعدت. في الجمعة التالية كان الخطيبُ من السلفية العلمية ولكنه شجاع، فذَكَرَ بعض الأخطاء الشرعية/ البدع التي وجدها في الكتاب وحذر الناس من تداوله.. بعد أسبوع نقلت “الأوقاف” الخطيب المحذّر إلى مدينة ثانية، ثم قال أهل المنقول إنه مسجون معزول في سجن صهيونيّ. منذ تلك اللحظة بدأت أنظر له بطريقة مختلفة.
///
كنت أتقلقل. متضايق من وجوده في الصالون، لكن لا حيلة لدي. ويعينني من ناحيته بالسكوت وتأمّل البلاط. يحدث بي شيء لا ألِّمُّ به ولكني أحسّه، فأصغيت لذاكرتي وهي تتوسّع: منذ عقد تقريباً أتتني دعوة الكترونية للكتابة في مجلة شهيرة (نسيت المناسبة). مرسل الرسالة لم يكن رئيس تحرير المجلة مباشرة، إنما تمريراً من زميل هو الذي، كما أُريد لي أن أفهم، اقترح اسمي، ويتوجب علي بالتالي أن أكون ممنوناً له شاكرا.. ووُجِّهت الدعوة لعدة أشخاص وكانوا يعرفون عن بعضهم، ومن بينهم خالد.. باعتباره كاتباً. وقعت في حرج شديد لأنني كنت قد نشرت مقالة طويلة تتحدّث عن شخصية افتراضية لكنها تحيل بتفاصيلها الدقيقة له تحديداً؛ فإذا قبلت الدعوة تحت إغراء شهرة المجلة والبدل المالي والعلاقة مع رئيس التحرير (الكبير) فإنني عندئذ سأقرّ أن حقيقة الشخصية الافتراضية لا تهمني، وأكون، ضمنياً، قد تقبلت وجود خائن نشرت قناعتي فيه، ما يجعل كلامي كله بلا قيمة، ويجعلني مجرد باحث عن منفعة.
وإذا رفضت المشاركة -أو صرحت بسبب الرفض- ورّطت نفسي وأكّدت أنني أعنيه هو في حين المسألة، شرعاً، بحاجة إلى أدلة ثابتة، وكل ما لدي عبارة عن تحليلات وملاحظات. أما في الكتابة الافتراضية فلست بحاجة لدليل، يمكنني أن أصور أيّ شيء كما أراه بخيالي، والحكم متروك للقارئ الذي يقتنع به أو لا يقتنع، فيستطيع رفض تصوري كلّه أو تصويبه أو تعزيزه بتجربته.
ذهبت إلى صديقي في مكتبه وافتعلت معه شجارا وشتمته لأنه لم يستأذن مني قبل اقتراح اسمي واتهمته أنه يحاول الصعود على ظهري، وأرسلت رداً الكترونيا إلى رئيس التحرير رافضا المشاركة. لم يصدق أحد شجاري وكانوا يعيدون، جميعاً، السبب إلى المقالة، وكنت أنكر طبعاً. تبيّن لي أنّ الدعوة كانت فخاً وأن مقالتي أحالت إلى أكثر من خالد فُرجة.. بعدها ساءت الأمور وهاجمتني حركته في افتتاحية نشرتها الشهرية، وانتقدني كثيرون وقاطعني آخرون، أما رئيس التحرير (الكبير) فلم يترك شخصاً يعرفه إلا وشهّر بي أمامه، أنا الذي تجرأت على رفض الكتابة لمجلته العريقة.
لقد لفتُّ النظر لا إلى خالد فُرجة فقط، بل وإلى حقيقة أنني أتتبعه من دون امتلاك صفة تسمح لي بذلك، فارتدّ الأمر عليّ.. وبحثت عمّن يساندني ولو بكلمة، فوجدتهم قد سبقوني إليهم جميعاً: اعطوا منحة لابن صديقي المحرر الذي كان ينشر لي في الصحيفة المحلية (ثم جعلوه مستشاراً لدار النشر التي يمتلكها خالد فُرجة) وتوالت لأشهر كثيرة التحقيقات الصحفية والمقالات والتقارير عن أخبار دار النشر وأنشطتها. لقد اشتروه؛ ووظفوا مسؤولي التنظيمي القديم الذي يعود للانتفاضة الأولى –وكنت أحسب صلتي به سرية- باحثاً في مؤسسة نسوية تطرقتُ إلى دور مثيلاتها في تغيير تركيبة الأسرة عن طريق هدم القوامة، مع أنّ تخصصه هو التربية الرياضيّة (وهاجم بالاسم طروحاتي اللاوطنية المتخلّفة المحتقرة للأقليات والمرأة)!
زوجتي طلقتني بيسر لم اسمع عن مثله في أيّ محكمة شرعية وأخذت ابنتي التي كانت في الثانية عشرة معها، وقفزت من موظفة تعمل في مشروع بعقد مؤقت إلى مديرة مكتب دائمة، دفعة واحدة.
ثم صدمتني عربة كان يجرها بغل ظهرت فجأة من خلف شاحنة احتلت الرصيف وأجبرتني على المشي في الشارع، وفرّ صاحبها وتركني على الأرض!
لم أصدق أنّ شرطة كاملة بمباحثها ومخبريها يعجزون عن إيجاد عربة يجرها بغل في مدينة لا تحتوي إلا القليل منها. وجدت نفسي مجبّر الساقين في المستشفى لا أملك حتى ثمن العلاج. بعد ثلاثة شهور أخرجني أولاد الحلال وأوصلوني إلى المنزل، مشلولا لا أمل في أن أسير ثانية. في اليوم التالي زارني موظف صندوق التعويضات، وخيّرني –صراحةً- “بين مبلغ كبير مقطوع على أن أسافر من دون عودة، أو مساعدة شهرية وممرض يزورني يومياً مقابل..” سحب أصابعه على فمه.
أخبرته أنني اختار زيارة ابنتي (التي لم تأتِ قط).
كنت أعرف أنّ الأمور متداخلة وأنني حين أضرب بؤرتهم التي يشتغلون عليها منذ سنوات سيستهدفونني بدورهم، لكن لم يخطر لي أنّ الرد سيكون جماعياً، تغطيه مؤسّسات محلية (إعلامية وأهلية) وأجهزة أمن وحركة يفترض أنها إسلامية/ وطنية.
عندئذ أدركت أنّ الساحة –بأكملها- مرتّبة، وأنّ المرء وحده لا يستطيع مجابهتها، ولا بد من جماعة. الجماعة، أي جماعة، لها قوانينها وضوابطها ونقاط ضعفها. صحيح أنها قد تحمي، لكن من السهل أيضاً إحراجها، إذا كان المهاجِم المحرِّج يمتلك وجوهاً دولية ووطنية واجتماعية بل ودينية أيضاً (فالسلفيون مثلا، في كلّ الدول العربية، أدوات للأنظمة). عندئذ لا يلزمك سوى خطأ واحد تقترفه لتتخلى عنك الجماعة، وتجد نفسك وراء الشمس!
أفضّل أن أكون وحدي: إذا أحسنت في شيء فللجميع وإذا أسأت فعلى نفسي فقط. منذ مراهقتي، بمفردات ذاك العهد، أحسست كأنّي أعرف قدري: سأربح دائماً كقضية، وسأخسر دائماً كشخص.
ما كان لي أن أتعرض لخالد أو أتتبعه مباشرة، كما فعلت. كان عليّ أن أومئ إيماءً وأشير إشارةً واللبيب يفهم من تلقاء نفسه. لقد درست كل كلمة كتبها وكل كتاب وافق على نشره وكل خطبة مسجلة استطعت الحصول عليها وكل مخيم تعرض لاجتياح زاره (بعد الاجتياح وكتب عنه) بل ودرست أخطاءه اللغوية وأصالة معجمه ولغته الأصلية التي يفكر بها (الانجليزية) ومعتقداته الحقيقية (من خلال صوره الفنية العفوية في الموضوع المعيّن، أو تداعيه اللا إرادي..) وخرجت بنتائج رهيبة. ودرست حيثيات اعتقاله وأين أنفق معظم حكمه (مستشفى السجن) وكيف اختار زوجته. وجدت أن آثاره دائماً مزدوجة التأويل. ثم قررت بيني وبين نفسي أنه إذا كان تحليلي سليماً فسأنجح في التوقع. وتوقعت أن يستهدف –مستقبلاً- الجامعة فمسار تلميعه ونمذجته يقتضيان أن يصل إليها، لأن الطلاب هناك هم الشريحة الرئيسة المؤثرة في الساحة.. وبالفعل حصل هذا بدايةً من خلال الندوة التي شارك فيها ماركسي وعلماني وأدارتها مسيحية، ثم صار المحترم بعدها من ضيوف الجامعة الدائمين.
أبو يزن أحد الذين قاطعوني.. أتى لمنزلي ليخبرني أنه، نكاية بي، سيعرض في مكتبته كتب الشيخ خالد بنصف الثمن.. بل ومن دون ربح، لينشرها على أوسع نطاق، ثم ألقى على الأرض رُزمَتيّ كتابي الوحيد الذي كان معروضاً في مكتبته ولم تنفذ منه سوى عدة نسخ.
///
وانتفِض لا أصدق ما سمعته من أبي يزن وأنّه سأل، إن كنت كتبت عن “الموضوع” ليساعدني على نشره؟؟
كان في نظرته شيء مؤذٍ، ترصدي.. نبرة صوته ودّية، محايدة، لكنها منخفضة وأقل من المألوف. إنها، بالضبط، حالة التحقق من افتراض دفين. تذكّرت ما قرأته مرة عن رسول الله، أن كل الذين عرض عليهم الإسلام كانت لديهم برهة تردد.. باستثناء أبي بكر. أحسست أنه يشير لتلك النظرة في العينين التي هي مزيج من خوف وتغور وتساؤل وشك وعدم فهم.. في حالتي، عندما تتعقلن هذه النظرة، تصبح باردة، قاسية، تنتظر التمكّن لتنقضَّ بلا رحمة، ولا مناص من مجابهتها لأن أي إشارة للارتباك أو الضعف ستفسّر سلباً. لقد رأيت تلك النظرة في عيون كل الذين عرفتهم، ومعهم ابنتي حين جذبتها أمها من ذراعها وهمست في أذنها شيئاً ثم خرجت بها!
ذكّرني بها أبو يزن الذي يحاول استدراجي. إذ لا يستطيع أن يعترف –هو وغيره- أنني كنت بعيد النظر، وما دمت عادياً مثلهم، فلا بد أنني متورط في الموضوع بطريقة ما لأستطيع معرفة شيء جهلوه هم، من معطيات كانت أمامهم طوال الوقت.
- لم أعد مهتما بهذه الأمور.
- هل ما تزال لديك نسخ من كتابك القديم؟؟
لا أصدق أيضاً أنّ الحقير يسأل عن هذا، بعد أن ألقى الرزمتين. لكن لا: من يبحث عن الظهور فسيركب كل موجة، ومن يبتغ الربح لا تهمه السلعة، ومن يطمع بالسائد إنما هو مقلّد مزيّف ليست لديه قدرة على التمييز أو الرؤية. لنفرض أنني استعدت كل ما خسرته، فهل سأنسى، للحظة واحدة فقط، أن هؤلاء الحمقى يستطيعون بغبائهم تدميري؟
رغم الكرسي المدولب، كنت أستطيع العمل في أكثر من وظيفة عرضت عليّ. غير أنّي كنت أتأمل المعنيين (رئيس التحرير، المدير المباشر، مساعد الوكيل..) وأتساءل: هل يعوّل على هؤلاء في حالة خضت صداماً أدبياً أو فكرياً ولا أقول سياسيًا أو أمنيًا؟؟ ولا أجهل ما يفعلونه: يدفعون غبيًا مخلصًا نزيهًا ليحرث ويزرع ويتعب، ثم يحصدون هم نتائج عمله بعد تحوير الأهداف التي سعى المسكين لتحقيقها!
ثمّ إني رأيت:
= هذا ليصبح وكيل وزارة أو دبلوماسياً، باع رئيسه المبجّل عندما حوصر مع أنه تملق إليه بعدة كتب، وجرّ إليه الوفود، والتقط معه مئات الصور، وأخذ منه عشرات الموافقات/التوقيعات على ميزانيات واقتراحات ومشاريع..
= ذاك الذي قبل أن يكون “مندوبًا” في الجامعة ينتهك خصوصيات زملائه ويتلمّس عوراتهم ويستعملها في تطويعهم أو يبتزهم بها، كعادة حركة معينة، ألن يبيعني ليصبح، مثلاً، نقابيًا يُشار إليه بالبنان؟؟
= وسمعت كيف يمكن للشاعر الرقيق “الذي يتخاطب مع جانبه الأنثويّ” أن ينقلب ضابط مخابرات ساديًا يعذّب ويستبيح.. خصوصًا الذكور!
= والثوريّ بطبعه، أكثر الناس مبدئيّة، فسينحاز في النهاية للأيديولوجيا.. ما من وحشيّة تضاهي وحشية ثوريّ وصل السلطة عندما يشعر بتهديد فقدانها، عندها سيستبدّ خصوصًا ضد العقائديّين ومن تخلوا عن الأيديولوجيا.
لقد انتهيت من الناس والأوطان والأيديولوجيا والإنسانية برمّتها. ولولا كلام الله، لقلتُ: الإنسان أحقر المخلوقات على الإطلاق.
أخبرته بالحقيقة كما هي:
- جمعت في حياتي حوالي ألفي كتاب ما بين فكر وسياسة وأدب وعلم نفس.. الخ. ألقيت بها كلها في حاوية النفايات ومعها كتابي أنا نفسي. لم أبقِ إلاّ على كتاب الله وكتب قليلة منها السيرة وكتبي التخصّصية في الجامعة.
اِنتفض مصعوقاً كأنني بصقت في وجهه، هو صاحب المكتبة الذي يستفسر عن جديد لي لينشره أو قديم ليعرضه.
- لم أتصوّر يومًا أنك ستصير هكذا.. العلم يا رجل لا..
أشرت له بيدي أن يتوقف: لا تعطيني رجاءً هذه المحاضرة!
سكبت حثالة القهوة في الدلو القريب وشطفت الركوة بماء من زجاجة اللترين، وملأت الركوة إلى منتصفها ووضعتها على الطباخ الكهربائيّ الصينيّ، ثم شغّلته. سألته باستخفاف:
- كيف تشرب قهوتك؟؟
كان ما يزال مصدوما ساهماً في شيء ما فلم يفهم ما قلته. أعدت عليه السؤال، ففهم ونهض مرتّبًا بدلته. تغيرت ملامحه وربما ذهبت عنه كل تلك الادعاءات.. التودّد والحماسة والتقرّب، وسمعته يقول:
- من واجب المسلم أن يصفح عن أخيه المسلم وأن يجد له عذرًا..
أين كان هذا الصفح وإيجاد العذر طوال تلك السنوات؟؟ فأجبته ناقماً:
- لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين!
حين جذب أبو يزن الباب ليخرج، دخل القط وماءَ مواءه الجائع الذي أميّزه، كما أميّز مواء لهوه وشعوره بالوحدة، أو مواءه الثالث/طلبه لفتح الباب والخروج.
(21/10/2014)