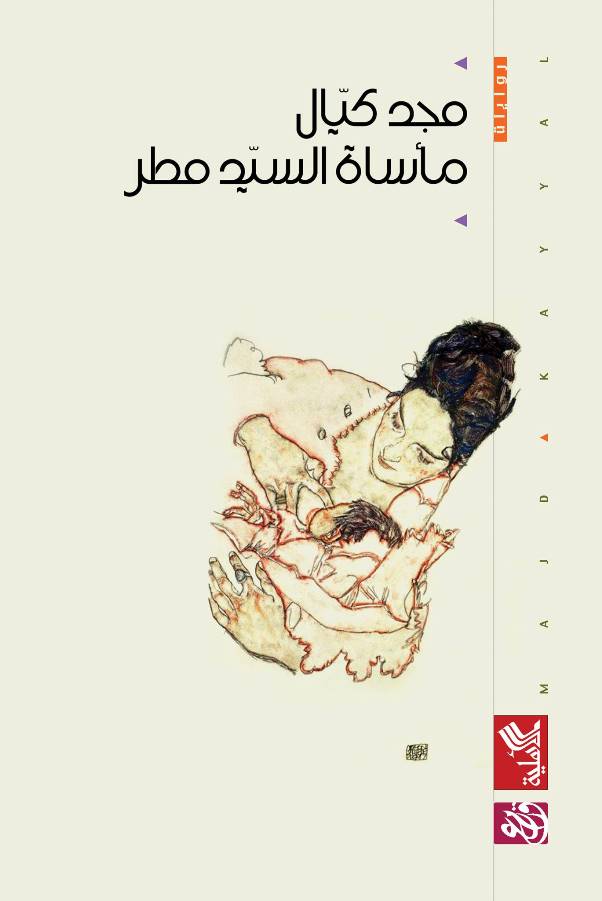بيـاضٌ مُفـعمٌ بالـدّم: عن رواية “مأساة السّيّد مطر”/ صالح حبيب
أنابَ الرّاوي شخصيّةَ السيّد مطر عنّا جميعًا بتهكّم صامتٍ ودمويّ لمأساةٍ يعتادُها العربيّ، مأساةِ الإدراكِ ● هذا الفضاءُ غيرُ المنتهي، يقذفُنا إلى هاويةٍ روائيةٍ لا يخرجُ منها القارئ إلا حامِلا تعاسَتَه، وَعصبَ القلب، قلبِ البلادِ المذبوحةِ… ولا تموتُ
.
|صالح حبيب|
هناكَ ما يدورُ كفلكٍ في فضاءٍ لا يتماسَكُ إلا بالجاذبية؛ يدورُ ويدورُ، ثمّ ينفجرُ دفعةً واحدة. هكذا تتسلّط اللغةُ وتأوي كقطّ على شيء دافئ.
ربّما سقطَ المتلقي تواليًا مِن شدّة وكثرةِ الحميميّة السّردية، فوقعَ بين جبهتين لم تفترقا على مدّ النّص: التوليفةِ الحدثيةِ بكلّ ميزاتِها والحوارِ المحفوفِ بالأنا الضائعة.
إنّ التشابكَ معَ الإشاراتِ والإقتباساتِ في الرّوايةِ عجّل مِن ضرورةِ الضياعِ التي صبا إليها الكاتبُ، الضياع النفسي بمثيولوجيا التاريخ الأدبي والفكري المشتق مِنَ المأساة، المأساةِ الجمعيةِ لكلّ ذاتٍ فلسطينية/ إنسانية، من بشرٍ وحجر. فالفكرةُ غير مُستمدّة وإنما قد تكونُ مُتخيّلة أو داعمةً على أنّها ذاتُ الدّهشةِ أو طرقةٌ تتوازى والألم.
لم تتَبنّ الروايةُ/ الكاتبُ منظومةً جاهزةً كقالَب أدبيّ يُعتمد عليهِ فنيّا؛ فالزّمن المُتغيّر(كدلالة حاضرة) يُنغّصُ ترتيبَ المشاهد الّتي تتفاوتُ وتتداخلُ وتُنثَرُ على مسرحٍ لا يُعنى بالزّمن كبديهة لحدوث عملٍ أو حلقةٍ يحينُ إقفالُها.
كيفَ كان التّعاملُ معَ الشخصيّات؟
لنبدأ بالقول: ليس هناك مِن شخصيّة نمطيّة تكشفُ ظاهرَها لنُكاشِف باطنَها، أو بالعكس. هناكَ ريبةٌ منَ الحقيقة أو خوفٌ منَ المعرفة، معرفة الذّات. فكلّ واحدة منها تبتعدُ وتغورُ في أسبابِ الحياةِ أو الموتِ على السّواء.. فالحياةُ مكلفةٌ والموتُ ثمين.
هذا هو الصراعُ، ذاتُهُ، المتنقّل والمُتحوّل. فالسيّد مطر “لم يكن سيد قد وُلد ليعرف إن كانت تلك حياته الحقيقية أم أنها مجرد حلم…” (ص27). ويتوالى الموتُ كما تتوالى الحياةُ؛ دادو مارسَ الحياةَ مع إلينور فقُتل، “تلك هي ثمار الحبّ” (ص53).
أليستِ الخيانةُ أيضًا مدرجًا للحياةِ معَ أنها موتٌ لذيذ؟ الصورة واضحة: الشّخصيات تلعبُ دورَ الحياة. هكذا ندورُ باحثينَ عمّا يُسمّى بالبطل، السيّد مطر، دادو، رقيّة، البحر، ديمة… حيفا، أم الرّاوي؟ جميعهم يشكّلون الورقة الناقصة، جميعهم بطلٌ واحد.
نحنُ أمام لوحةٍ مضطربة، متقاطعة، يبدأها الكاتبُ بالقلق أو بالغرق: “في البدء كانت رغبة الإنسان في السّباحة، ومن ثمّ كان البحرُ، أزرقَ هادئًا..” (ص7)، كما في العهد القديم وبالتّوازي “في البدء كانت الكلمة…”. هنا عملية الخلق تبدأ مجاراةً للطبيعة… البحر كفاعل أوّل والكلمة هناك كفعلِ حياة وبداية، لكنّ الأمور لا تسيرُ كما يتشهّاها المتلقّي، أو كما عليها أن تكون فعلًا. فالولادة كانت إطارًا للسّكت لا للإنفعال، وحفرةً عميقة للصمت لا للصّخبِ الأوّل المُتمثّل بالصرخةِ الأولى، “… يواصلان الرّكض، هي نحو سراب السّيد مطر، وهو خلفها ضاحكًا” (ص 18)، “كان الضّوء يموت…” (ص 21)، وهنا يظهر خفوت الولادة التي لم تكن أصلا، أو كانت مؤتملةً ليس أكثر.
السيّد مطر نائمٌ كَنومِ مومياءَ، أو كنَومِ شعبٍ يشعُرُ ولا يستفيقُ إلّا لُمامًا. فالزّمن غيرُ محسوسٍ عند هذه الشخصيةِ المُكوّرة على السّرير، لكنّها تشعرُ، ومِن شعورها ترى الخيانةَ
يبدأ الجنوحُ نحو ما يُسمّى بالطفولة، طفولة مَن؟ أهو ذات الجنين الميت؟ “الطفل الذي لم يولد صار كبيرًا ودخل المدرسة” (ص 29)، نراهُ يلعب، يدخل إلى الصفّ، يجلس تحت شجرة الخروب، يُرجعه أمنون إلى الصفّ، كلّ ذلك يدلّ على حقيقة وجود السيّد مطر، ويتم التأكد من ذلك عند قوله: “أستاذ أمنون! اليوم عيد ميلادي!” وعند التحقق من صحة كلام سيّد عند المعلمة “مدّت شفتها السفلى بصمت ودونما إجابة” (ص 33). هذه صورة قد تُفسّر عدم نجاح المعلمّة في رؤيتها لسيّد مطر، إلا وقد تسأل عن حقيقة الأمر، تسأل الطفل على أقلّ إهتمام.
لكنها، نعم، لا تراه.
وديمة؟ تراهُ ويبتسمان الواحد للآخر، كأنّ لعبةً يفهمانها هما دونَ غيرِهما.
وفجأةً يُفتحُ بابٌ جديدٌ، من دونَ أيّ تمهيدٍ مُسبق، قد يكون هربًا منْ السّرّ، سرّ أو لغز السيد مطر، الذي لا مخرجَ منهُ إلا الهرب كحلّ مؤقت عندَ الرّاوي، دخولًا إلى ثُكنة أخرى: أمنون. هذا الإنتقالُ المفاجئ يُحدثُ خللًا في منطقِ تناولِ خيوطِ الحدثِ التي تاهت تفاصيلهُ. فهذا الفصلُ مشتبِك، لم يستطعِ الراوي الربطَ بين الحادثيْن، حادثِ طفولة سيد مطر وحادثِ أمنون المتراخي بعلاقتِه معَ الحادث الأول.
يضعنا الراوي أمامَ لوحات عريضة أهمّها العقاب، للوصولِ إلى الحقيقة، حقيقة إلينور، ومعَ تراكم الجملِ القصيرة نكون قد إختلطنا وخرجنا ودخلنا في ما نظن أنه غيرُ مرتبطٍ منطقيّا بالحدث الأصلي، هذا التهافتُ غير المتوقع ينشر التساؤلاتِ سميكةً، أهمها: هل أنا مدرك ما أقرأ؟
هذا تساؤل ينسحب على كلّ من يتناول فصل “الطفولة”، وقد اتهمت كيّال، حينها، بالهَذيِ.
يُوكل أمنون مهمةَ التقصّي لدادو بِمراقبة إلينور، فعقل أمنون مليء بالأسئلة، يريد معرفة ما إذا كانت إلينور في علاقة مع غيره، “كان لا بدّ ﻹلينور أن تعاشر رجلا آخر ليغلق أمنون دوائره وأسئلته” (ص 48). هذا تمهيد واضح وغير بريء فنيا لتدخل الراوي بالفكرة (الحلّ) التي يصرح عنها ويكاشفها، إضافةً إلى إذابةِ النّهايةِ بالسّرد الوصفي: “كان المسدسُ خفيفًا بينما قلب أمنون ثقيلًا… فلقّمهُ بمخزن الرّصاص” (ص51)، وهذا ما أفقد الصعقةَ من وقعها المنشود، إذ بدَتْ نهايةُ هذا المشهدِ مُتوقّعةً بواسطةِ التّمهيد الفارع.
بياضٌ مُفعمٌ بالدّم!
يختزلُ الرّاوي الزّمن ليؤثّثَ حاضرًا يعتليهِ الصّمتُ، الصّمتُ الدّالّ، والزّمن يجري في محاورَ عديدةٍ منها الشّخصيات ومنها، بفعلِ الحالِ، الأحداث. لكننا نُشدَهُ بالزّمن غيرِ الفاعلِ على السيّد مطر وهوَ نائمٌ كَنومِ مومياءَ، أو كنَومِ شعبٍ يشعُرُ ولا يستفيقُ إلّا لُمامًا.
فالزّمن غيرُ محسوسٍ عند هذه الشخصيةِ المُكوّرة على السّرير، لكنّها تشعرُ، ومِن شعورها ترى الخيانةَ.
هناكَ خليطٌ منَ الإستفهامات؛ والعالمَ الرّوائي في فصل “الورطة” لا يُختصرُ على المكان (حيفا، وشوارِعها)، ولا على مفهومِنا العام للرّواية، الفلسطينيّة تحديدًا. فقد أنابَ الرّاوي شخصيّةَ السيّد مطر عنّا جميعًا بتهكّم صامتٍ ودمويّ لمأساةٍ يعتادُها العربيّ، مأساةِ الإدراكِ. ويعتمدُ كيّال في هذا الفصل على منظومةِ النّفَس الطويل، حيثُ لا وجود لعلامات ترقيميّة ما يستدعي القراءة المتواصلة (ص 89 حتى 94). هذا التلاحقُ السّرديّ محفوفُ بمخاوف الشخصيّات (الراوي، ديمة والسيّد مطر) المعلنة منها وغير المعلنة. فالتلاحقُ مثلًا يُجاري وتيرة المُضاجعة التي حدثت قبلًا، تمهيدًا لهذا التلاحق السّرديّ: “كانت… تطلب مني أن أُسرعَ الإيقاع” (ص 88). عندها ندخلُ من جديد في دائرةٍ لا مَخرجَ منها، أوسع بكثير مما كُنّا نظنّها “…أما ديمة فهي أم وديمة تعرفُ كلّ شيء” (ص 94). فديمة هي الوحيدة التي تعرفُ كلّ الأجوبة، أجوبة الأسئلة المزروعة في رأس كلّ مَن يتناول هذا النّص، إنّها أسئلة زُرِعت لِتكبر.
السيد مطر أمام المحقق، الثاني يعاني، أشياء متخيلة، غير واقعة، ضيق حال، إزدواجية، الشروع بالقتل، هَذيٌ وتفوقٌ جنونيّ… كلّ هذا في سلة واحدة، سلة الضياع.
التخبّط النفسيّ عند السيد مطر يفضي إلى حالة تتعمّق تدريجيا وتنصب تحت إطار مليء بالعتمة، وذلك يولد وبتخمة نصّا تعتليه المأساةُ النفسية التي تلحق المتلقي من حين إلى آخر: “الأشياء يا سيدي كانت تتحدّث إلي، تبوح تارة، وتصرخ بي تارة أخرى.” (ص 101).
علينا بالحَيطة، بل وأكثرَ مِن ذلك؛ فالجهات مفتوحةٌ كالرّموز، تقعُ ونحنُ أشباهُ مدركين لفعلِها، فعند موت/ انتحار السيد مطر “…الأرض المضرّجة تمتلئ بقشور الليمون” (ص 118)، نذهبُ إلى ما هو محفوفٌ أكثر بالجنسِ منهْ إلى الموت: “ما أن اقتربا حتى شاهدت رقية شجرة ليمون لم تعرف قبل الآنَ أنّها موجودةٌ” (ص 13)؛ “الليمون من أمي، إنّها ثمار الحب…” (ص 110).
معَ كلّ تناقضٍ نبدأ بالتناقص، كأنّ شيئًا يتآكلُ على التّوالي، يعودُ ويحاولُ اكتمالًا من دونَ جدوى. هذا الفضاءُ غيرُ المنتهي، يقذفُنا إلى هاويةٍ روائيةٍ لا يخرجُ منها القارئ إلا حامِلا تعاسَتَه، وَعصبَ القلب، قلبِ البلادِ المذبوحةِ… ولا تموتُ.